تعد تجربة الشاعر العراقي طالب عبد العزيز واحدة من أبرز التجارب الشعرية في الشعر العراقي، هذه التجربة الممتدة على مدار ما يزيد من ربع قرن والتي حملت الكثير من الفرادة في رؤيتها وأفكارها، بدءًا بديوان "تاريخ الأسى" في 1994، ومرورًا بدواوين "ما لا يفضحه السراج"، و"تاسوعاء"، و"الخصيبي"، و"طريقان على الماء.. واحد على اليابسة"، و"خمس وستون حبة رمل في شاحنة كبيرة"، ووصولًا إلى "مديح علبة الألوان" الصادر في 2024. ولم يقتصر مشوار طالب عبد العزيز الذي ولد بـ "أبو الخصيب" في مدينة البصرة عام 1954، على الشعر وحده، فنشرت له عدة مؤلفات منها "قبل خراب البصرة"، و"أبي الخصيب".
النخل والسفرجل يطل من كتابات عبد العزيز الشعرية والمؤلفة، تأثرًا بطابع وسحر واقعه الذي عاش فيه لعقود طويلة، لا سيما كتابه "قبل خراب البصرة" الذي ألقى فيه الضوء على سيرة الماء والنخل. فازت قصيدته "العشاء الأخير" بجائزة مجلة اللوتس، التي كان ينظمها اتحاد أدباء وكتّاب آسيا وإفريقيا في تونس عام 1991، كما فاز ديوانه "تاريخ الأسى" بجائزة أفضل كتاب شعري عام 1994، ونشرت مجلة "إتلانتك ريفيو" التي تصدر عن جامعة اتلانتا الأمريكية ترجمة لبعض قصائده ضمن عدد تناول الشعر العراقي تحت عنوان "زهرة النار".
وحول شهادته التي يدلى بها لبوابة "دار الهلال" يقول الشاعر العراقي طالب عبد العزيز: (وأنا صبيّ، لم أبلغ السادسة عشرة بعد، كتبت قصيدة قصيرة، مختلة الوزن، لا أتذكرها الآن، لكنْها كانت بهذا المعنى: "في الليلة الموحشة هذه، وكرجل لم يحسن اختياره في شيء، لا أطلب لليلتي هذه أكثر من امرأة جميلة، محلولة الشّعر، تقف على بابي، وتسمعني شعرًا، لم أقرأه كشاهدٍ في كتاب النحو"، ويبدو أنَّ طلبي المبكر لم يأخذ طريقه إلى السماء، إذ لم يكُ موزونًا، مقفى، كما تريد الألهة، ويطيب لشياطين الكلام سماعه، لذا مددت يدي إلى الشاعر والمعلم، عبد العزيز عسير، لأطلعه على ما كتبت، حيث سبق أنْ هداني لقراءة "ميزان الذهب في صناعة شعر العرب" لأحمد الهاشمي، فكان عصيًا عليَّ، ثم أنني كنت طالبًا كسولًا، بطيئ الفهم، أستعجل الشعر، كما يستعجل الفتى المُغتلِمُ فتاه، أريد الشعر، وليس غيره، وأرى بأنني حتى أتعلم الكتابة بالوزن سيفوتني الكثير منه، وهذه مشغلة عن الشعر الذي يسكنني، وأيّ معنى ليوم يمضي لا أكتب قصيدة فيه. كان الشعر عندي سمكة تلبط بين يدي، غزالًا شاردًا، في برية لا تحدُّ، لذا فمن العبث أن أتركه).
ويضيف: (بين عاميّ 1970-1971 كنت أصغر الجالسين على كراسي مديرية رعاية الشباب، التي قدمني إلى منصتها الشاعر نزار الناصح، وقرأت قصيدة صغيرة، كنت ابن ستة عشر عامًا، كان الشاعر عسير قد أصلح لغتها، وقوّم وزنها. في نهاية العام 1971 أهداني أحدهم كتاب نيتشة "هكذا تكلم زرادشت" ومن مصروفي اليومي اشتريتُ ديوان "شموع المعبد" لفؤاد الخشن، أحفظُ إلى الآن َ"فأتلقْ يا معبد النجوى بنا/ إنما نحن شموع المعبد"، ثم اشتريت ديوان"الحبُّ أحلى" لعبد الكريم شمس الدين من بائع يصيح في سوق بالعشار (إثْقَفْ بدرهم)، وديوان "أزهار ذابلة" لبدر شاكر السياب، وكذلك ديوان مظفر النواب(للريل وحمد). وفي السنة تلك أحببتُ أول امرأة كان اسمها خولة، ولأجلها كنت أرددُ مطلع معلقة طرفة بن العبد "لخولةَ أطلالٌ ببرقةَ").
ويتابع: (في نهاية العام 1969 كان الشعراء البصريون ينشرون قصائدهم في جريدة "الثغر" التي يحرر الشاعر عبد الرزاق حسين صفحتها الثقافية، ولمّا كانت أسماؤهم تعتلي قصائدهم كان الحسدُ ينخر قلبي، وتأكلني الغيرة، فقد كان نشر قصيدة لي ضربًا من عظمة لا يبلغها أحد، ولأنَّ كتابة الشعر بالوزن كان اشتراطًا للنشر فقد طلبتُ من الشاعر عسير أن يقوّم وزنَ قصيدتي، وحين تمَّ ذلك لي بعثتُ بها إلى مجلة، كانت تصدر في بغداد، وهكذا رأيتُ اسمي وهو يصطف مع اسماء شعراء العاصمة. ياه، ما أكبرني صبيّاً، ما أجملني شاعراً! لكنْ، وفي غمرة فرحي هذا، كنت أشعرُ بأنَّ قصيدتي المنشورة لم تكن خاصتي، فقد تغيّرت الحروف، وسويت الكلمات، بعد أنْ أجرى المعلمُ الشاعر عسير مبضعه في جسد حروفي وكلماتي، فقد أضاف، واستبدل، وحذف، وغيَّر كلماتٍ ومعانٍ كثيرة، ولم تعدْ لي تلك القصيدة، التي أردتها أن تعبّر عمّا في نفسي، فقد عبَّرَ بعضُها عمّا في نفسه، وضاعت مشيئتي في بحر مشيئته الكبيرة، ولمَا كان الزمن يمرُّ بزهره وعوسجه على الروح الشاعر، ويسحق بكعبيه الجسد الضئيل آنذاك فقد آلمني أنْ تدوس قدمُ غيري عشبَة روحي، ولا أريدُ أنْ أسقي أشجاري بماءِ أحدٍ سواي، وهكذا، نسيت القصيدة تلك، ونسيت قصائد كثيرةً غيرها. لكن، لا ضير من الخجل والألم والتجاهل وأخطاء اللغة والوزن، بما فيها عثرات اللسان، وسقطات القلم، فقد تعلمت الدرس الأول، وجنيت ثمر الصفعات، إذ كلُّ عثرة لسان في حضرة شاعر كبير صفعة على الوجه، لذلك لم تعد الرغبة بالنشر غايةً أسعى لها، ولا إغراء في الأمر، بل هو الحذر الذي لا بدَّ منه، وهكذا صارت منصة الشعر واطئةً، وبلا معنى، ثم ضؤلت بعين الشاعر المحافل والمهرجانات، وصغُر المجد والإغراء، إذ ليس الأمرُ كيف تكتب؟ بل ماذا تكتب، فتوقفت طويلاً وتركت الكتابة والنشر عشر سنين، منصرفًا إلى القراءة والصمت والتجريب، حتى حلَّ العام 1979 حيث نشرتُ في مجلة الدكتور صلاح خالص "الثقافة" قصيدةً أظنها من المتدارك").
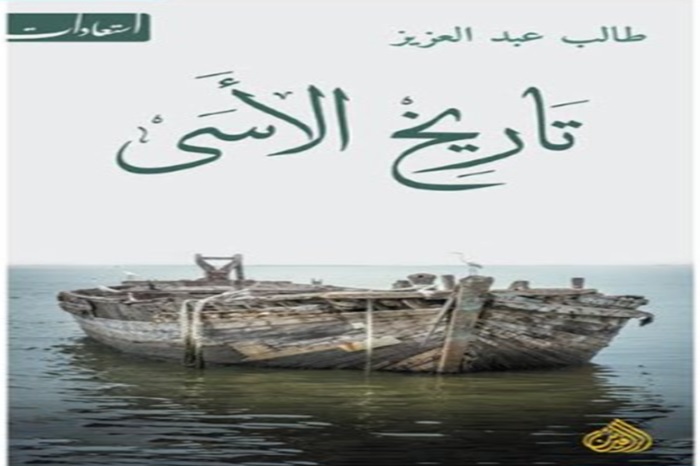
ويشير: (لا أظنَّ شاعرًا عراقيًا من "جيل" الستينيات والسبعينيات والأجيال اللاحقة لم يقتن نسخة من كتاب سمير الحاج شاهين عن رامبو، أو كتاب "رامبو.. آثاره وشعره" بترجمه خليل خوري، وصدر ببغداد في العام 1973. لقد فعل رامبو شاعرًا وملعونًا ما لم يفعله أيُّ كتاب في الشعر، عبث هذا المخلوق بسلوك وحياة وشعر عشرات الشعراء العراقيين آنذاك، ويشرفني أنني كنت واحدًا من هؤلاء، الذين سارعوا لأقتناء نسخته منه، وأشهد أنني، وقعت أسير طفولته، ونزقه، وصلفه قبل أنْ أقع أسير شعره، هذا المجنون المشرد الشاعر الذي هزَّ العالمَ من أذنيه، بتعبير هنري ميلر).
ويؤكد: (لا أحتفظُ في مكتبتي اليوم بأيِّ كتاب للعروض، إذْ كلُّ ما كان فيها لم يعدْ، فقد أهديتُ بعضها للشعراء المبتدئين، وتخلصتُ من البعض الآخر في دُرجٍ عميقة، مظلمة، لستُ نادماً، ولا أشعر بخيبة كبيرة، كما يظنُّ البعض، أبداً، فمعرفة العروض وإتقان الصنعة، والإحاطة بالبحور وتفريعاتها علمٌ وتسليةٌ جميلةٌ، ومشغلةٌ أجمل، أذهبُ لها، وألهو بها إلى اليوم، ومن مقامي المتواضع هذا أكبرُ شأن شعراء الوزن الذين يخفون بحور الخليل، في جميل شعرهم، ولا نشعر معهم بأهمية وجدوى العروض، فيطغى الشعر خالصًا عظيمًا، وأشهدُ الله أنَّ سعدي يوسف كان واحدهم).
ويلفت: (لا يمكن اختصار التجربة بكلمات على الورقة القصيرة هذه، لكنْ، وبعد فترة الصمت التي استمرت عشر سنوات(1969-1979) والتي أمضيتها قارئًا قبل أن أكون شاعرًا، منصتًا إلى ذاتي، مراقبًا ما يحدث ويدور حولي، متابعًا لما ينشر في الصحف والمجلات، غير مشارك في أي فعالية من الفعاليات، بقيت خارج المشهد بالتمام حتى نهاية العام 1979 كما قلت، حيث نشرتُ القصيدة الثانية في مجلة الثقافة البغدادية، القريبة بتوجهاتها من اليسار العراقي، وبعد ذلك صرتُ أنشر في مجلات العاصمة (الطليعة الأدبية والأقلام) وفي العام 1980 اندلعت الحرب العراقية –الإيرانية، التي أُخذتُ جندياً فيها، وتحولتُ من شاعر إلى جنديّ، كان عليَّ أنْ أمضي سنوات أخرى صامتًا، قبل أنْ استعيد ذاتي شاعرًا مرةً أخرى، فأتممتُ قصائد كتابي الأول (تاريخ الأسى) لكنني لم أدفع به إلى النشر إلا في العام 1993 مع أنَّ قصائدة تنتمي إلى فترة نهاية السبعينات والثمانينات).
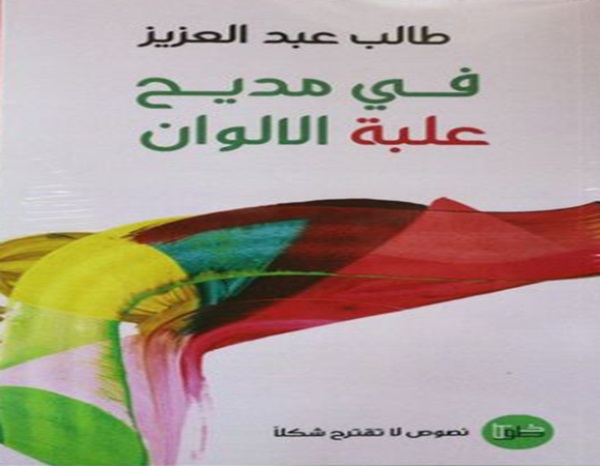
ويخلص طالب عبد العزيز في شهادته قائلًا: (الظرف السياسي المضطرب في البلاد والمعروف بتقلباته أيام نظام صدام حسين، وبسبب من انتمائي السابق للحزب الشيوعي جعلت مني ومن نخب مثقفي اليسار العراقيين بعامة مترددين، وخائفين من بطش السلطة، فمساحة المحظورات والممنوعات كانت شاسعة جدًا، كما أنَّ ظروف الحرب والحصار والتي امتدت بآلتها لعقدين من الزمن، ألقت بظلالها على الجميع، وبمعنى ما، لم تكن فضاءات الحياة في العراق فضاءات ثقافيةً، فالبلاد محجوب عنها كل كتاب، ولا تدخله الصحافة العربية والأجنبية أيضًا، وكذلك المطبوعات العربية، الأمر الذي جعل المثقف العراقي يعيش في جزيرة نائية، حتى العام 1993، والذي أصبحت عمّان/ الأردن فيه رئته الوحيدة، ونافذته التي تطل على العالم. لذا غادرتُ البصرة بنية الهجرة، لكنني عدت بعد ثلاثة أشهر، فقد كانت الحياة ضيقة هناك، ولم أطق السكن في غرفة صغيرة مع مجموعة متنافرة الأهواء والأمزجة، فضلاً عن الحاجة القاتلة للمال، وبعد سقوط النظام السابق علي أيدي القوات الأمريكية وتمتع البلاد بهامش نوعي من الحرية تمكنت من استعادة حياتي في المدينة والشعر، وعملت في الصحافة، وسافرت، وشاركت في مؤتمرات ثقافية، عديدة، داخل وخارج العراق، وأصدرت أكثر من عشرة كتب في الشعر والسرد، فأنا اليوم وبحسب ما يقوله الأصدقاء اسم حاضر في أنشطة الثقافة بالبصرة وبغداد وخارج العراق).