فى زمنٍ انجرف فيه كثير من الأدباء نحو العاصمة، ظل الناقد والكاتب شوقى بدر يوسف متمسكًا بمدينته الإسكندرية، عاشقًا لأزقتها البحرية، حارسًا لذاكرتها، مواظبًا على الحضور فى المشهد الثقافى كناقد وصاحب رؤية فى مجال السرد، متابعًا بشغف تحولات القصة القصيرة والرواية، مشرفًا على الورش الأدبية، ومانحًا من خبرته أجيالاً متعاقبة من الكتاب الشبان.
ورغم تقاعده الوظيفى منذ أكثر من ربع قرن، من مجال لا يمت بصلة للأدب، لم يتوقف قلمه لحظة، كتب ونشر فى أغلب الدوريات الأدبية العربية، وترك بصمة واضحة فى النقد الأدبى العربى، حتى جاءه التقدير مؤخرًا عبر جائزة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى (الدورة 21) تكريمًا لمسيرته المتفردة.
بعد تكريمك من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.. كيف تقيم تجربتك ورحلتك الإبداعية بعد كل هذه العقود فى الكتابة والقراءة؟
لا شك أنه تكريم طيب لدورى الثقافى خلال نصف قرن، أصدرت خلاله 27 كتابًا نقديًا، آخرها كتابان صدرا فى معرض القاهرة للكتاب الماضى، وهما: (القصة ورأس الرجل، دراسة فى عالم محمد حافظ رجب القصصى)، والثانى (الرواية الشهرزادية، دراسة فى الإبداع النسائى)، ولأنى مهتم بالتخصص، وبالسرد أساسًا، فكل كتبى عن عوالم السرد، ومنها (دراسات فى القصة القصيرة )، و(دراسات فى الرواية )، (دراسات فى الأدب العالمى)، (دراسات فى الرواية الإفريقية)، (ببلوجرافيا عن نجيب محفوظ فى ستة مجلدات)، وصدر الجزء الأول منها فى الاحتفال بمئويته سنة 2011م، وكنت التقيته مرتين قبل وفاته بستة أشهر، واحدة مع القاص السكندرى محمد الجمل، والثانية فى ندوة شلة الحرافيش مع الناشر إبراهيم المعلم، وأحمد الله أنى ما زلت أمسك بالقلم رغم تجاوزى الثمانين، وما زلت أحضر الندوات، وأشارك فى الحياة الثقافية بقوة، وآخر ما كتبت دراسة عن رواية (وقائع حارة الزعفرانى) لجمال الغيطانى، وقد سلمتها لمجلة (الثقافة الجديدة) ضمن ملف تعده المجلة عنه للعدد القادم، كما ذهبت لقصر ثقافة الشاطبى مساء السبت لإلقاء محاضرة عن الروائى الألمانى (أريك ماريان) صاحبة رواية الحرب الأشهر (الكل هادى فى الجبهة الغربية)، وللأسف لم أجد غير ثلاثة من الحضور فاعتذرت ومشيت، وآسفت أننا وصلنا لهذا المستوى، وتذكرت أننا فى شبابنا كنا نفضل الحضور الثقافى على الأكل والشرب، ويبدو أن (السوشيال ميديا) أثرت سلبًا على الحضور الشخصى فى الندوات، لقد اختفى نقاد كبار مؤخرًا، وأنا فى طريقى للاختفاء!.
كتبت عن القاص السكندرى ابن جيلك محمد حافظ رجب.. بماذا تصف مسيرته؟
محمد حافظ رجب جدد على مستوى الشكل السردى، وكل جيل يحاول أن يختلف عن الجيل السابق عليه، كما كان الجيل السابق عليه من أمثال يوسف الشارونى وبدر الديب يحاول التجديد عن جيل يوسف إدريس ومحفوظ ومكاوى والبدوى، وأنا أصف محمد حافظ رجب بالمتمرد، فقد تمرد أولاً على أبيه صاحب محل بيع الفول والفلافل فى محطة الرمل، وعمل فى مهن متواضعة، ثم كتب القصة السريالية، ثم اصطدم بالكاتب يوسف السباعى عندما كان يمثل السلطة الثقافية، فتمرد عليه وعلى ما يمثله.
أمازلت عند رأيك أن كل أديب سكندرى يلمع يغادر إلى القاهرة؟
نعم، حيث القاهرة ملتقى المؤتمرات والندوات الكبرى، وبها الحكومة والمؤسسات، ودور النشر الكبرى، وصناع القرار، فعل ذلك كل من محمد جبريل، وإبراهيم عبدالمجيد، وأسامة أنور عكاشة، وعبدالفتاح رزق، ومحمد عبدالله عيسى، وإدوار الخراط، وغيرهم، فالمشهد الثقافى فى الإسكندرية منذ الستينيات كان غنيًا، وأستطيع أن أحصى لكم عددًا كبيرًا من الأسماء المتميزة مثل: (محمد حافظ رجب، ومحمود عوض عبدالعال، ومحمدالجمل، ومحمدالصاوى، ومصطفى نصر، وسعيد سالم، وسعيد بكر، وفؤاد الحلو،..)، فالإسكندرية معمل لتفريخ الأدباء، ولكن كلما برز أحدهم رحل للقاهرة، وكلهم يكتبون عن الإسكندرية، ومثلاً محمد جبريل تخصص فى الكتابة عن (بحرى والأنفوشى)، وكتب محمد الصاوى (عين سمكة وسكر مر)، وكتب كل من نجيب محفوظ وفتحى غانم عن الإسكندرية، وهما ليسا من أبنائها، وكتب الغربيون عنها مثل: (كفافيس، ولورانس دراليل، ومشيل برغيش)، والأخير يونانى وكتب رواية ( أوديسا العصر الحديث)، وترجمها د. حسن عون، كما ترجم د. نعيم عطية لآخرين كثر كتبوا عنها، كما كتب (جورجيوس فيلبوس) عن المشتغلين بالقطن.
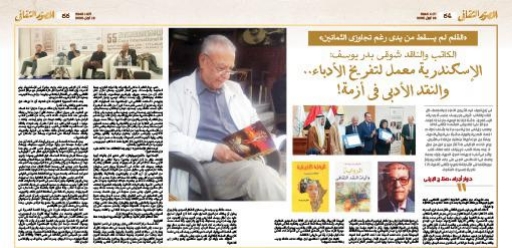
كيف تنظر للإسكندرية اليوم وما الاختلاف عما كانت عليه قبل نصف قرن؟
الإسكندرية «الكوزموبوليتان» التى تضم كل جاليات أوربا اختفت، وكل ما كان أجنبيًا، وشعبيًا جميلاً اختفى مع الثورة الأولى سنة 1952م ثم مع السبعينيات وعصر الانفتاح وظهرت طبقات جديدة، لقد نشأت فى (الحضرة) بجوار قصر سليمان باشا الفرنساوى، وفى مقابل صفين من الفيلات الجميلة، وكان من الطبيعى أن أرى الأرمن واليونانيين والطلاينة والإنجليز والفرنساويين كل يوم، وكانت لنا صداقات متينة معهم، كل هذا اختفى، واختفت عاداتهم، وظهرت طبقات اجتماعية جديدة، حتى المقاهى الأدبية والصالونات الثقافية والندوات الشهيرة اختفت، مثل صالون يوسف الجزايرلى فى محرم بك، ومحمد حافظ رجب فى مقهى النيل، وعلى حسن حمودة فى جبل ناعسة، ومحمد زكى العشماوى فى قصر التذوق، وكان محمد الجمل يعقد ندوة فى بيته، وكانت قصور الثقافة واجهات مضيئة وتؤدى دورًا مهمًا مثل (الحرية والشاطبى والتذوق والإبداع)، وكل هذا اختفى، ويكاد يكون دوره معدومًا، فالندوات هزيلة، والدعم محدود، حتى إن مكتبة الإسكندرية منعزلة عن محيطها الثقافى، واكتفت بدورها السياحى والسياسى، وسيطرت البيروقراطية.
ماذا فعلتم أنتم كأدباء ومثقفى الإسكندرية لمواجهة هذا التراجع؟
لقد أسسنا مركزًا للنقد الأدبى قبل ربع قرن فى (قصر التذوق) مع محمد زكى العشماوى، وحاولنا ونجحنا فى عقد ندوات كثيرة، ونشرنا فى مجالات الشعر والقصة والرواية والمسرحية، وأضفنا أدباء ونقادًا من القاهرة، وحاولنا استضافة نقاد الجامعة الذين تسيطر الأكاديمية على مشروعاتهم ولا يحتكون بالساحة الأدبية كليًا، وفى النهاية نحن نعانى والحركة النقدية تعانى، والقاهرة أخذت كل الزخم، ومع ذلك بقيت جنديًا فى الإسكندرية، ولم أغادرها، وإن كنت أزور القاهرة كل فترة للتواصل مع مراكز العمل الثقافى، وأكتب فى (الهلال) بانتظام، وغيرها، وراضٍ بما أقوم به، وسعيد لأن القلم لم يسقط من يدى.
بعد هذه المسيرة الطويلة، هل شعرت أن ما زرعته من جهد نقدى وثقافى قد أثمر؟
نعم، والحمد لله، شعرت بأن هناك مردودًا حقيقيًا لما قدمته عبر العقود. على سبيل المثال، سعدت كثيرًا حين جاءتنى باحثة ماجستير منذ عدة سنوات، كانت تُعد رسالة عن القاص الشاب الراحل ضياء الشرقاوى، وكانت تبحث عن جذور إبداعه. وكنت – حينها – الوحيد الذى كتب عنه كتابًا نقديًا، وقد شبهته بثلاثة من أعمدة السرد: كافكا فى الغرب، جورج سالم فى سوريا، ومحمد الرواى، حيث رأيتهم أضلاع مثلث متشابه فى الرؤية والتجربة. ولاحقًا، حصلت الباحثة على الدكتوراه برسالة عن «المكان فى الإسكندرية».
ومن المحطات المهمة فى مسيرتى أيضًا، أننى كنت أول من كتب دراسة موسعة عن رواية ميرامار لنجيب محفوظ، وربطت الرواية بالبنسيون الحقيقى الذى يحمل نفس الاسم. يقع هذا البنسيون فى عمارة قديمة بالطابق الرابع، تطل على الكورنيش، بين محطة الرمل ومنطقة السلسلة، قبل الشاطبى وسينما راديو، نشرت هذه الدراسة فى عدد مارس 2003 من مجلة الهلال، وذكرت فيها أن محفوظ كان ينزل بالفعل فى هذا البنسيون، واستلهم منه شخصية عامر وجدى، التى جسدها لاحقًا الفنان عماد عبدالحليم. أما شخصية زهرة الخادمة، فاستوحاها من فتاة حقيقية كانت تعمل لدى أحد أصدقائه، وقدمت دورها ببراعة الفنانة شادية فى الفيلم.
أنا أعتبر نفسى متابعًا دؤوبًا للحركة الثقافية منذ الستينيات وحتى اليوم، والتقيت بكبار أدباء مصر فى الندوات والفعاليات. كنت أعتز كثيرًا بنجيب محفوظ، وبمحمود البدوى.. فى زمننا، كنا نعانى من صعوبة النشر، وكنا نطبع كتبنا بأنفسنا على «الماستر» فى السبعينيات، ونعرض أعمالنا على أساتذتنا الكبار للنقد والتوجيه. أما اليوم، فالجيل الجديد متعجل فى الوصول، رغم أن فرص النشر أصبحت متاحة أكثر بكثير، خاصة مع وسائل التواصل والسوشيال ميديا. مشكلتهم أن قراءاتهم بلا منهج ولا تراكم حقيقى، وهذا ينعكس على ضعف كثير من كتاباتهم.
كما أشرفت لسنوات طويلة على ورشة القصة القصيرة فى قصر التذوق، وقدمت من خلالها أجيالًاً كثيرة من الموهوبين، من مختلف الأعمار. لم نكتفِ بالأدب العربى، بل انفتحنا على آداب العالم، وأنا شخصيًا مغرم بفن القصة القصيرة، وأراه فنًا راقيًا وجميلاً. أعددت دراسة عن رباعية الإسكندرية للورانس داريل، كما نشرت كتابًا نقديًا عن عبدالرحمن منيف والرواية السياسية، وكنت عضوًا فى هيئة تحرير مجلة الكلمة المعاصرة، وفزت بجائزة النقد من المجلس الأعلى للثقافة فى عامى 1989 و1990، لكنى لاحقًا تجاوزت مرحلة الجوائز، وصرت أكتب بدافع الحب والإخلاص للإبداع ذاته.