يهدى الشاعر العراقي كمال العبدلي ديوانه الجديد "مفازة الغربة" إلى "جميع الأدباء العراقيين والعرب بلا استثناء.. ذكرى إضمامة الكلمة المُشعّة في عالم الوجود"، ويحمل تجربة شعرية تشكل إضافة إلى ما وتماسا مع نسيج قدمه في دواوينه "أيتها النائمة في رحمٍ ما" و"المتأمل بين العين والنهر" وله وديوانه الصادر باللغة الإنكليزية "لا نسينغ كرنفال شعري" وكذا كتاب في السيرة الأدبية "البيئة الأدبية حاضنة الإبداع "، وأيضا كتاب "فوتوغرافيا الأوراق، قضايا أدبية" وما نشره من قصائد ومقالات أدبية في الجرائد والمجلات العربية .
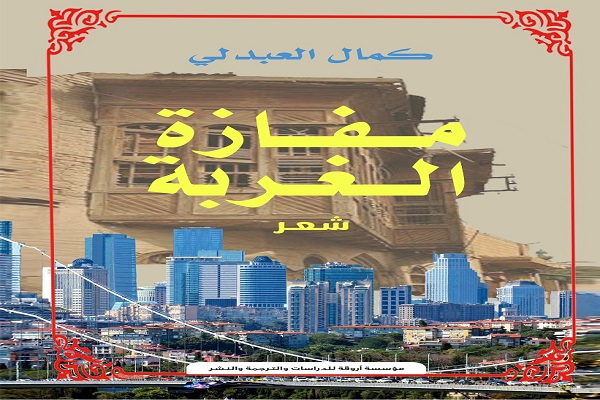
ويدرج العبدلي في مفتتح ديوانه الصادر عن مؤسسة أروقة مقالتين نقديتين الأولى " قِراءة أولى للمُنجَزِ الشِعري للشاعر كمال العبدلي: قصيدة السؤال والحزن الإنساني" للناقد د.حاتم الصكر، والثانية "مقاربة نقدية في تجربة الشاعر كمال العبدلي" للناقد د.عزيز التميمي، حيث يرى الصكر تجربةُ الشاعر كمال العبدلي تنقلنا إلى زمن العافيةِ الشعرية وازدهارها عبر مشروعات التحديث التي بدأها جيله الشعري، مستكملاً ثورةَ الروّاد في منتصف الأربعينيات للانتقال بالقصيدة من التقليد إلى التفعيلة الحُرّة والبيتِ الشعريِّ المستجيب للدلالة وغرض الشاعر، وليس للنظم والهيجانات اللغويّة وافتعال التقفية وعلوِّ الموسيقى ووضوح المعاني، الذي لا يدع مجالاً للقارئ باتّجاهِ التفكير بمغزى الشعر. يمكن لنا تجييل العبدليّ ضمن جيل الستينيات الذي استكملَ المشروعَ الرياديَّ والذي نصِفهُ بـ (التجديد)، ونقله خطوةً أوسعَ صوبَ (التحديث)، وبين التجديد والتحديثِ اتّخذت تجربةُ العبدليّ مرجعيّتَها الشكليةَ والموضوعية.
ويقول "استوقفتني في حديثِ العبدليّ لمؤلِّفِ موسوعةِ (أقلام مَهجريّة) مسألتان، الأولى: تفريقُهُ بين القراءةِ البصريّة لقصيدة الحداثة، وبين الاستماعِ المنبريّ لقصيدة العمود، إذ يقول:(إنه يكتب قصيدةَ الحداثة ؛ لما تتيح لهُ من مدياتٍ مفتوحةٍ على الغوص في الذات وولوجِ الرؤيا وليس كما تفعل القصيدةُ العموديةُ التي تزيح المُخيَّلةَ لترتطم بالقافية..)، والمسألةُ الثانية تتعلق بالمزايا الشفهيّة التي يتنازل عنها شعراءُ الحداثة؛ لكونِها صوتيةً عابرةً وصَفَها العبدليُّ في حديثه أيضاً فقال: (القصيدةُ المنبريّةُ تتّسع لما ينتظمها من جرس الإيقاع، فيما تتطلب قصيدةُ الحداثةِ، القراءةَ البصريّة). لا تحدّ كتابةَ العبدليِّ الشعريّةَ حدودٌ ولا يضعُ نفسَه في خانقٍ فنّيٍ أو جَمالي، فهو يكتبُ التفعيلةَ وقصيدةَ النثر وبحماسةٍ وحيويّةٍ تنعكس على نصوصِهِ قديمها وجديدها، فها هوَ يكتبُ القصائدَ القصار ذات الكثافةِ والتركيز ببراعة، تستثمرُ طاقاتِ هذا الشكلِ الجدّيّ، وأمثّل لذلك بنموذجٍ من مُبتكَرَةٍ له:
"لو لمْ تكُن للضياء
صورةٌ أخرى
لَما شاهدهُ الأعمى".
وبنموذجٍ آخر من ديوانه (المتأمّل بين العين والنهر) يتمثّل في قصيدة بعنوان (مسافات):
"كيف يُمكِن
أن أحسبَ للشمسِ
هذا البُعد
وهي تلامِسُ يدي وملابسي؟
وأنْ أحسب بُعدَ الموت
وهو جالسٌ على عتباتِ
كلِّ أبوابي؟
وأنْ أحسبَ لِحياتي
هذا القربَ
وهيَ أبعدُ ما تكون عنّي؟"
يلاحظ قارئ قصائد العبدليّ أنّه من ضِمنِ جيل الستينيات المهزوم بالنكبات والتعثّرات والخسائرِ التي انعكست على ذوات الشعراء خاصةً، وأنتجتْ هذا التمرّدَ والدورانَ حول الذات التي رأينا كيف يمجّدها العبدلي في حديثهِ ذاك وفي النموذجَين اللذين استشهدنا بهما.ويُلفتُ نظرَ القارئ، الاستفهامُ بكثرةِ الأسئلة في شعر العبدلي، ليؤشِّرَ لنا ذلك بأنه مهمومٌ بالسؤال كنايةً عن عدم التيقّن ممّا في الحياة من مرتكَزاتٍ هزّتها العواصفُ والرياحُ العاتية التي أطّرتْ شِعرَ جيله. لا يعني ذلك أنّ الشاعرَ لا يضع للجمال والحبِّ والحياة مكاناً في شعرهِ، بل سنجدهُ حزيناً ومستفهِماً من أجل تلك القيم الغائبة التي يؤمن بها.
"إن كنتُ حزيناً
فذلك لأنّي
أختزنُ الفرحَ المؤجَّلَ على الدوام."
هذا النَصّ بعنوان (حزُن)، وهو مثالٌ جيّد للتكثيف وللرَمز اللذَين يتّسمُ بهما نصُّ العبدلي على المستوى الفنّي والأداء.
ويضيف الصكر "حين يكون الوطنُ موضوعاً لقصيدة العبدلي، فإنَّ العراقَ يأتي بهيئة أخرى ليست هي التي تمثله كسَكَنٍ أو ذكرى قديمةٍ فحسب، فالمسافاتُ بين الشاعرِ ووطنهِ بسبب الاغتراب ليست كافيةً للنسيان أو الصمت إزاء ما يجري من أهوالٍ وأزماتٍ عاصفة، ولدينا شواهدُ من نصوصهِ تؤكّدُ ذلك، لعلّ أبرزَها دلالةً قصيدتُهُ (تاجٌ أنتَ ياعراق)، فهي أشبه بصرخة شوق وألم:
"من بعيد
كالمخنوق
أتلمّسُ بريقَ القباب الذهبية
المرفوعةِ فوق أضرحتِك المُقدَّسة
يا عراق".
لقد تقابلت المسافةُ هنا بين المُغترَب والوطن، وجرى وصفُ الاختناق بعيداً عن القباب التي ترمزُ لحزنِ الوطن وجمالهِ معاً.
أمّا عن الماضي الحضاري للعراق فيقول العبدلي بكثافةٍ واقتصاد:
"ليست جنائنكِ ....يا بابل
هي المُعلَّقة
بل هي روحي المُعلَّقة."
إنَّ القراءةَ النقديّةَ الفاحصةَ لشعرِ العبدلي ستتوفّر على دلالاتٍ مُعمَّقة رغم بساطة العبارةِ والبُعد عن التعقيدِ والغموض المُفرغ، وهو ما نراه يتراكم في نصوصٍ كثيرة تتوهّمُ الانتماء للحداثة.
وفي مقاربته النقدية يقول د.عزيز التميمي "الحديث عن تجربة الشاعر كمال العبدلي يعني الخوض في الحداثة الشعرية، وما تعنيه قصيدة النثر في مصطلح الحداثة الشعرية. والمتتبع لحكاية النشأة والتطور لهذا الوليد الشعري الذي تمرد إن صح التعبير على القولبة العروضية التي رسمت المشهد التعريفي للقصيدة العربية لقرون طويلة. بل تجاوزت هذه الهيمنة للحدود المعرفية للقصيدة ونفذت إلى الإحداثيات السلوكية والنفسية للبنية المجتمعية، وصارت تتمازج مع تعريف مفاهيم الخير والشر وملامح الشخصية وغرائزها. وبعد هذا التجذر والتناسل العروضي في ذاكرة تعتاش الملحمة والأسطورة والخرافة والإرث الديني، حضرت قصيدة النثر، لتطرح الأسئلة من جديد. ومن هنا بدأت المكابدة بين جيل يؤمن بالعروض ويؤمن بالتغيير والتجديد وبين جيل لا يرى في التجديد جدوى، وللحقيقة لم يكن المنحى التجديدي محلي النشأة بل كان تماهيا مع موجات الحداثة الغربية، وهذا لا يعد عيباً فقراءة التجارب الحداثية واستشفاف روحها ريادة بحد ذاتها.
ويتابع التميمي "قصده النثر التي اجتذبت العبدلي إلى حقولها تمخّصت عن نص يتناغم مع طروحات الحداثة ويسمو بها إلى مناطق معرفية وكونية غيّرت كثيراً في النص الشعري، بل أثّرت كثيراً في اشتغالات أجناس أدبية أخرى كالرواية والقصة والمسرح في الأدب العربي. لم تكن كتابة الشعر بطريقة النثر سهلة كما يتخيلها البعض، بل هي مكابدة فلسفية قبل أن تكون مغامرة لغوية، يقول بورخس في كتابه (صنعة الشعر) لقد بدأت بالاعتقاد أن الشعر الحر أو الشعر المنثور هو أسهل من الأشكال المقيدة إلى قواعد وقوالب قديمة ثابتة، وأنا اليوم شبه متأكد من أن بيت الشعر الحر أصعب بكثير من الأشكال الموزونة والكلاسيكية التقليدية.
ويؤكد أن العبدلي ساهم وبشكل كبير في تدوين المنجز الشعري ضمن مساحات قصيدة النثر في العراق تحديداً وكان متفاعلاً مع طروحات الأسماء المبدعة التي تبنّت هذا الاتجاه، مثل سركون بولص وفاضل العزاوي، وطبعاً لا ننسى الشاعر حسين مردان الذي وصفه الكثير من النقاد على أنه من الرواد المؤسسين لهذا النص المسمى بقصيدة النثر، وشخص الشاعر حسن سلمان لحضور اسم حسين مردان كاول من كتب قصيدة نثر تحت مسمى (النثر المركّز). لم يكن العبدلي مهتماً بفكرة الأجيال الشعرية التي مورست قسراً في تاريخ الشعر العراقي، بل يرى القصيدة كأنها دفق مستمر يجايل فكرة الوجود والإنسان والحب. كان مستفزاً ومتأملاً حاذقاً في سبعينيات القرن الماضي، ومنشغلاً في معترك الإبداع في العقد الثمانيني، لم يدع الزمن يغلفه في المحن اللاحقة، انحاز لقضية الإنسان وكان متشائماً إزاء ما يتعرض له الوطن والحياة في بلاد الرافدين في العقود اللاحقة.
ويتوقف التميمي عند أبرز الملامح الفنية لقصيدة العبدلي، ومنها:
أولا المخيلة الجامحة: قصيدة النثر تمحورت على طرح الرؤية الفلسفية ضمن مفهوم الصورة المجازية المؤثثة بأدوات مخيلة جامحة، القصيدة عند كمال العبدلي تؤسس مناخاتها وعمقها على دعائم مخيلة مترفة، مخيلة تتناسل فيها الصور والأمكنة والأزمنة ضمن حرية مفعمة بالتأويل، لا تؤمن بالحدود الآنية للكتابة، تخوض في الوجع المتوارب في حواضن التاريخ والجغرافية، هي هنا ضمن أمكنة نعرفها وهناك في تخوم أساطير مؤولة لنا في ذاكرة جمع من العراّفين والخونة وربما أدعياء وكذّابين.
ثانيا اللغة المرهفة: اللغة هي شفرة الإيصالية بالمفهوم الفسلجي، اللغة هي النسيج المتشكل في الذاكرة عقب عملية التأويل، لغة كمال العبدلي الشعرية مربكة أحياناً ولذيذة في أحيان أخرى، لغة شفافة تتشظى في الأسماع لا بدافع التعتيم بل محاولة تشكيل واستثارة، تحفز الركود لتبني التساؤل، تتواءم وكثرة الاستفهامات لتنتج الصورة الغنية بالمعنى، تتعالى عن رتابة الصياغة، تعترك في اختيار المفردة، لتؤكد نبل الهم الإنساني الذي تقاسي استجلاءه.
ثالثا نقاء الرمز: الرمز في القصيدة دال معرفي يسهم في تأثيث الصورة الشعرية، والمتتبع لكتابات كمال العبدلي يكتشف رموزه، لم يتشدق برموز لا تنتمي إليه بل تفانى في صياغة رموزه التي تعرّف مساحات الوجع في مفهومه، تناول الوطن كرمز للانا الذاتية للكون، عرّف المرأة في كتاباته بأنها بيت كنهوتي مليء بالأسرارـ أيتها النائمة في رحم ما، المكان رمز وجودي في جملته الشعرية، والزمن رمز أزلي للتجدد، فكانت القصيدة في مفهومه رمزًا متشعبًا ذا جذور وانسجة بأديم ذاكرة متوقدة.
رابعا البعد الوجودي: ربما يتساءل الكثير منا عن ماهية البعد الوجودي في الأدب والشعر، البعد الوجودي عامل حاسم في تشكيل التوجه الفلسفي للكتابة الشعرية تحديدا، حينما تكون القناعات الوجودية للشاعر متشكلة ضمن إحساسه الشعري ستساهم بشكل أو بآخر في توجيه الجملة الشعرية. ومن خلال تواصلنا مع القصيدة عند كمال العبدلي نجد أن القصيدة عنده تنحو لتأسيس خطاب إنساني داعم لفلسفة الحياة المبررة، الحياة التي استحكمت أسئلتها وتجاوزت مفهوم البحث عن الأجوبة، الحب في قصيدة كمال العبدلي حب عقائدي لا حب عبثي، حب مؤسس على دعائم وجودية مبرهنة لا رغبات حائرة، القصيدة لا تتساءل عن مبررات الأنا بقدر ما تنشغل بتساؤلات الحياة، الحياة الكائنة ضمن حدث الخلق المستساغ. لم نقرأ للعبدلي قصائد تروج لأسئلة حائرة، بل تأتي طروحات القصيدة من خلال حميمية لوجود مبرهن ومبرر. ويمكننا القول إن القصيدة لا تنشعل بأسئلة الوجود بل تتعامل مع الوجود كمنطق محسوم وتنزغ لتأثيث حركة الفعل الوجودي للإنسان.
خامسا مغامرة التجديد: كان الشاعر كمال العبدلي مدركاً أن كتابة القصيدة بلغة نثرية تحتاج الكثير من العناء اللغوي والمعرفي، ولا تركن لمساحاتها المفتوحة التي تتيح للمخيلة الذهاب بعيداً في مسرحة الصور والمعاني، كان الشاعر يكتب بروح التجديد التي تطرح الكثير من الاستفهامات من خلال تحريك الجمل الشعرية ضمن أنساق متحولة ترصد الإرهاصات النفسية للمتلقي، مستثمراً الخصائص الغنية للغة العربية وتشابكها مع الإرثي والمثيولوجي.