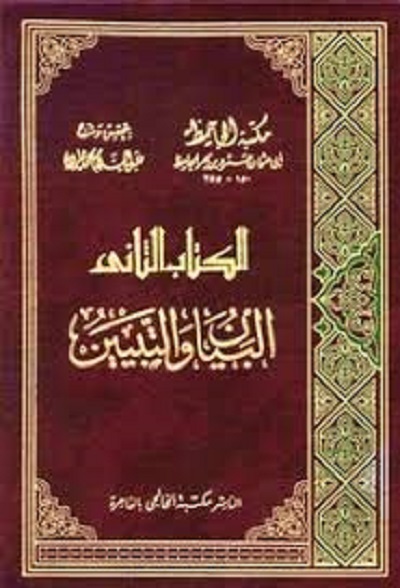لا يعرف كثيرون – الآن- عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أنه كان أديبًا مفكرًا يتجاوز بعبقريته حدود المكان "العراق" والزمان "القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي" وأنه فرض اسمه على تاريخ الأدب في العالم كله، وأنه الفيلسوف الذي عُرف بتنوع تصانيفه وعمقه في الكتابة وغزارة إنتاجه، ويمكن للباحث في الفلسفة والمنطق، وكذلك الباحث في السياسة والاقتصاد أو الاجتماع والأخلاق وعلم التربية وأيضًا الباحث في علم النفس، وعالِم الدين والبلاغة، كل هؤلاء يمكن لهم أن يستفيدوا من مصنفات الجاحظ ورسائله التي بلغت فيما ذكره لنا "سبط بن الجوزي" في كتابه "مرآة الزمان" ثلاثمائة وستين مصنفًا بعدد أيام السنة، وعن ذلك يحدثنا "سبط بن الجوزي" فيقول: "أما مصنفات الجاحظ فثلاثمائة وستون مصنفًا ووقفت على أكثرها في مشهد الإمام أبي حنيفة".
ويكلمنا المرزباني – وهو أديب مرموق من كبار الناثرين القدماء- عن الجاحظ فيقول: "كان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النَّظَّام، وكان واسع العلم بالكلام كثير التبحر، شديد الضبط لحدوده، وأعلم الناس به وبغيره من علوم الدنيا، وله كتب كثيرة مشهورة في نصرة الدين ومُحَاجَّة المخالفين، والآداب والأخلاق، وفي ضروبٍ من الجد والهزل. قد تداولها الناس وقرأوها وعرفوا فضلها".
أما المستشرق كارادي فيقول عنه في كتابه "مفكرو الإسلام: "إن الأفكار الجاحظية مفعمة بالعمق والاتساع، ورسائله جديرة بالبحث والدراسة؛ فرسالة التربيع والتدوير تشتمل على كثيرٍ من موضوعات العلوم المختلفة حتى لكأنها دائرة معارف، وإن الباحث لا يكاد يلتمس شيئًا من الحياة العربية حتى عصر الجاحظ إلا وجده في ثنايا كتابٍ من كتبه أو رسالة من رسائله".
نعم صدق كارادي فو، فإن الجاحظ يغمر محبي القراءة والمقبلين على الثقافة الرفيعة بوفرة مؤلفاته، ويصيبنا بالدهشة والانبهار عندما نقف على تصانيفه الكثيرة متعددة المجالات، فالجاحظ دون مبالغة كان آية زمانه، وفيه يتجلى قول الشاعر:
"وسرُّ العبقرية حين يسري.. فينتظم البدائعَ والفنون"
وأصالة الجاحظ في مؤلفاته كانت مضرب المثل؛ إذ لم يكن يكتب إلا بعد معرفة وفهم حتى إذا قرأ له القارئ في مجال أحس كأنه تخصص فيه وحده وأنه لا يحسن غيره من المعارف، ثم يتبدد هذا الشعور إذا انتقل القارئ إلى كتابٍ آخر في موضوعٍ مختلف، ولعل هذا كان مقصد أبي العيناء حين سأله سائل: أي شيء كان يحسن الجاحظ؟ فقال: بل قل: أي شيء كان لا يحسن الجاحظ؟!
وحتى يعرف القارئ الكريم شيئًا عن إنتاج هذا الكاتب القدير نذكر له أنه ترك لنا من ضمن كتبه "كتاب الحيوان" ويقع في سبعة أجزاء كبيرة، وهو موسوعة علمية كتبت بصياغة أدبية بليغة، وموضوع الكتاب كما يبدو لنا من اسمه: دراسة الحيوان من حيث أجناسه وطباعه وعاداته وفصائله ومرضه وصحته، وطب الحيوان، وتكاثره، وأغاريده – حين تكلم عن الطيور- وأعشاشه، باختصار كل ما يخص الحيوانات، وهي مادة ثقافية ممتعة تفيد الإنسان وتروح عنه وتنقله لعالم مختلف بعيدًا عن مشاكله وأحزانه ومخاوفه، ونعتقد بيقين أن هذا الكتاب مطلوب جدًا للوقت الذي نحن فيه؛ حيث أمراض العصر: القلق والاكتئاب... إلخ.
ومع أن هناك في تراثنا العربي كُتَّاب آخرون سبقوا الجاحظ إلى التأليف عن الحيوانات مثل: أبي حاتم السجستاني، النضر بن شميل، الأصمعي، أحمد بن حاتم الباهلي، أبي عبيد، وغيرهم، إلا أن "حيوان" الجاحظ كان فريدًا في بابه دالًا على أصالته من حيث الكم والكيف؛ آية ذلك أنه عالج موضوع "الحيوان" معالجة علمية رصينة تثير الفكر وتستدعي النظر والتأمل، ولم يقف على الجانب اللغوي وحده ولا قَصَد أن يستعرض فصاحته في اختيار الكلمات وبلاغته في صياغة العبارات.
وترك لنا الجاحظ أيضًا كتاب "البخلاء" ويتألف من جزئين، وفيه يعالج بأسلوب قصصي مسلي يعتمد على الحبكة الدرامية والتحليل النفسي عيبًا من أسوأ وأخطر العيوب الاجتماعية وهو موجود في عصرنا بوفرة! ألا وهو "البخل" والجاحظ هنا يتتبع شخصياته البخيلة ويسبر أغوار نفوسهم ويتعمق في تفاصيل حياتهم ويكشف مستور طبائعهم، ويستخدم في كل هذا أسلوبًا يغري الكاتب ويعجب القارئ وهو الأسلوب التهكمي الساخر الماكر المعتمد على المراوغة والجدل فيثير القارئ ويشحذ انتباه المثقف ويغري الأديب بهذا الأسلوب الذكي المخاتِل حتى ينسج على منواله ويستفيد هو الآخر من مخزونه الثقافي الخاص وخلاصة أفكاره، فالكتابة فن رائع لكنه مهضوم الحق في عصرنا هذا، ولا شك أن قراءة كتب الجاحظ من ضمن الحلول أكيدة المفعول لمعالجة أزمة الكتابة الراهنة وإخراجها من غلبة الثرثرة والغموض المصطنع وضعف القدرة على التواصل مع القارئ.
ولقائلٍ أن يقول: ما الجديد الذي أتى به الجاحظ في "البخلاء" وهذه أحاديث البخل وحكاياته كانت منتشرة في البيئة العربية قبل أن يصنف الجاحظ كتابه؟ فنقول حينئذٍ أن ميزة الجاحظ الحقيقية في "البخلاء" هي دراسته التأصيلية وتوسيع الكلام عن هذه الظاهرة الاجتماعية والتعمق في قراءة النفوس مع التحقيق العلمي المتزن والموضوعي الذي ابتعد به عن شوائب السياسة والعصبية القومية؛ إذ لم يكن الجاحظ يتعصب لجنس دون آخر، بل يكتب للإنسان في كل زمان وكل مكان، وهذا دون شك دليل أصالته والسبب المباشر في بقاء مؤلفاته حتى اليوم.
ونضيف إلى ما سبق أنه كتب في "الحيوان" و"البخلاء" موضوعات علمية بصياغة فنية واستطاع باقتدار وبراعة أن يمزج السخرية من شخصياته بالعطف عليهم، فهو في الحقيقة لا يسخر منهم ليتشفى أو يُنَفِّس عن حقد، بل كان يَضحَك ويُضحِك القارئ على البخلاء والحمقى والأشرار وفي نظير ذلك تبدو من كلماته آيات الحب للناس، وكل ما في الأمر أنه يكشف السلبيات ليتجنبها القراء ويجتهدوا ما وَسِعَهُم في الخلاص منها.. لقد كان الجاحظ أديبًا كبيرًا ورجلًا رحيما.
ومن الآيات الكبرى على أصالة الجاحظ وتفرده كتابه "البيان والتبيين" ويتكون من ثلاثة أجزاء نجد فيها حصيلة متميزة من الآثار الأدبية في الشعر والرسائل والأمثال والوصايا والحِكَم والخطابة، ونماذج من الأخلاق والطبائع، كما تطرق إلى قضايا أدبية وبلاغية، ويبدو من الكتاب أنه صُنِّف لغرض تعليمي ولهذا كان اسمه "البيان والتبيين".
ومن سمات كتب الجاحظ عمومًا أنه يُضَمِّنُها أشياءً من الطُرَف والنوادر والأحاجي (الألغاز) وهو بكل هذا يتوخى هدفًا نبيلًا هو الترويح عن القارئ وتنشيطه للقراءة والحياة عمومًا، ويمكن القول إنه كما نقول باللغة الدارجة "يفتح نفس القارئ" والحق أن الجاحظ كان أديبًا ماهرًا يدلل قارئه ويحرص على ترسيخ العلاقة النفسية والعقلية بينه وبين القراء، ومن حرصه أنه كان يعتني بعدم الإثقال على القارئ ولا يطيل عليه في موضوع واحد بل يشده إليه بالتنويع والتلوين، وهذا منهج ابتكره الجاحظ ونافَحَ عنه.
وإلى هذا المنهج يشير في مقدمة الجزء السادس من كتاب الحيوان" فيخبرنا أنه زين أبوابه بضروب الشعر والأحاديث، وما كان هذا إلا لأن النفس البشرية تمل من كل شيء إذا طال؛ حتى إنها لتمل من الأصوات الرخيمة والأغاني الجميلة إذا طالت!
ويمكن القول إن تنوع موضوعات الجاحظ ليس علة أصابته في آخر عمره كما قال البعض؛ وإنما منهج فني مبتكر يبتغيَّا متعة القارئ وتأكيد الصلة به، وقد دافع أديبنا عن هذا المنهج في مواضع من كتبٍ ألفها قبل أن يصل إلى الشيخوخة؛ مما يدل على حرصه على القارئ، وليت أدباءنا اليوم يقتدون به في هذا الاهتمام.
ونختم هذه المقالة بحكاية للجاحظ تنبؤنا كم كان راضيًا عن الحياة وعن نفسه، وأنه واجه ظروفه الصعبة بالابتسامة والفكاهة؛ فلقد كان الجاحظ دميم الخلقة ويمكن القول إنه كان "شبه زنجي" وقد سمي الجاحظ في الأساس لبروزٍ لافت في عينيه اللتين خرجتا من محجريهما، ومع هذا كان مرحًا غير معقد وكان يحب الضحك حتى من نفسه فهو يخبرنا أن امرأة أخذت بيده إلى النجار وقالت له: "مثل هذا" ومضت؛ فاستغرب الجاحظ وقال: ماذا تعني بقولها "مثل هذا"؟ فقال النجار: أتت إليَّ بالأمس وطلبت مني أن أصنع لها صورة من الخشب تخوف بها أولادها ليطيعوها، وأتت بك مثالًا!!
وذات مرة اجتهد الجاحظ في الدعاء فدخل عليه غلامه وقال: ما بك يا مولاي؟ فقال: يا بني وجدت نفسي قد أصبحت هُزؤاً للناس فأنا أدعو الله أن يصلح عيوبي؛ فقال الغلام: أيسر عليه يا سيدي أن يصنعك من جديد.
ومثل هذا كثير من الطُّرَف التي كان يستروح بها الجاحظ ويمتع سامعيه لأنه كان على سعة ثقافته وعمق حكمته ونزعته العلمية، ودودًا مرحًا بسيطًا محبًا للناس؛ ذلك هو الجاحظ الأديب الإنسان.